نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: فرنسا وفلسطين: من نابليون إلى ماكرون... ذاكرة إمبراطورية تبحث عن خلاص أخلاقي - تليجراف الخليج اليوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025 03:33 مساءً
قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، في جوهره، ليس قراراً دبلوماسياً عابراً أو مجرّد اصطفاف إنساني في لحظة مأزومة، إنما يمثل حلقة في سلسلة طويلة من محاولات فرنسا، كقوة كونية سابقة، لاستعادة دورها الأخلاقي والرمزي في العالم وتحديداً العربي. فمنذ حملة نابليون بونابرت على مصر وفلسطين عام 1799، وجريمته في عكا، وحين كان أول من خاطب اليهود واعداً إياهم بـ"استعادة وطنهم التاريخي"، مروراً بالجنرال ديغول الذي وصف إسرائيل في 1967 بأنها "شعب نخبوي ومهيمن"، وليس انتهاءً بفاليري جيسكار ديستان الذي حاول فتح نوافذ مع العالم العربي بعد صدمة النفط، بقيت فلسطين حاضرة في الذهنية الفرنسية كمسألة تعكس صراع القيم والمصالح، والتوتر بين الميراث الكولونيالي وطموحات الجمهورية الخامسة. اعتراف ماكرون اليوم لا يأتي من فراغ، بل في سياق طويل من محاولات فرنسا لإعادة ترسيم صورتها في المشرق، كقوة ليست استعمارية فقط، بل أيضاً "حامية للعدالة وحقوق الإنسان!!!!!". وبين الواقعية السياسية والإرث الثوري، يتشكل الموقف الفرنسي من فلسطين كمرآة لأسئلة فرنسا الأعمق عن دورها في عالم يتغير بجنون.
من منظور القانون الدولي، فإن الاعتراف الفرنسي ينسجم تماماً مع قرارات الأمم المتحدة، بدءًا من قرار التقسيم 181، وصولًا إلى قرار الجمعية العامة عام 2012 الذي منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو. هو تفعيل لمبدأ تقرير المصير، وإقرار بحق تاريخي وقانوني طالما تجاهله الغرب. فرنسا، باعترافها، لا تخرج عن المسار الأممي، بل تُحاول تصحيحه بعد عقود من التجاهل والتواطؤ. وإن كان بعضهم يرى في الخطوة خرقاً لمسار أوسلو، فإن الواقع يُثبت أن إسرائيل نفسها قتلت أوسلو بالممارسات الأحادية والاستيطان ورفض التفاوض، حتى غدت الدولة الفلسطينية وهماً على الورق، والاعتراف بها محاولة لإنقاذ ما تبقى من حل الدولتين.
ولئن جاء القرار متأخراً عقوداً، ومقارنة بمواقف دول أوروبية كإسبانيا وأيرلندا والنرويج المتقدمة، إلا أن رمزيته الفرنسية تحمل ثقلاً مضاعفاً؛ ليس فقط بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، بل أيضاً بما تمثله من إرث ثوري يستند إلى قيم الحرية والعدالة وتقرير المصير، وبما تُضمره الذاكرة من مفارقات. ففرنسا، التي تعترف اليوم بفلسطين، هي ذاتها التي ساعدت إسرائيل في الخفاء على بناء مفاعل ديمونا النووي في أواخر الخمسينيات، ووفرت لها التقنيات والمواد والتدريب، بعد تحالفهما في العدوان الثلاثي على مصر. لقد كانت فرنسا شريكة في صُنع ميزان قوى غير متكافئ في المنطقة، وهي اليوم تحاول تصحيح بعض من ذلك الخلل التاريخي، ولو من باب الرمزية المتأخرة.
أما دوافع الرئيس ماكرون، فهي مركبة ومتشابكة، تتداخل فيها اعتبارات السياسة الداخلية مع رهانات السياسة الخارجية. فالمزاج العام في فرنسا، بعد العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، أصبح أكثر تعاطفاً مع الفلسطينيين، لا سيما في الأوساط الشبابية والجامعية. الضغط الذي مارسته أحزاب اليسار، خاصة "فرنسا الأبية" بقيادة جان لوك ميلانشون، كان حاسماً كذلك في دفع الإليزيه لاتخاذ موقف واضح. أما اليمين المتطرف، بزعامة مارين لوبين، فيقف كعادته في صف إسرائيل، مستثمراً في الخوف من "الإسلام السياسي"، ومُوظفاً الملف الفلسطيني لتعزيز خطاب الهويّة. لكن المفاجأة الحقيقية تكمن في تراجع فاعلية اللوبي الصهيوني التقليدي داخل فرنسا، الذي ظل لعقود يمسك بخيوط حساسة في الإعلام والثقافة وصناعة القرار. لقد واجه هذه المرة بيئة شعبية وإعلامية أكثر نقداً وحدةً، وطبقة سياسية بدأت تُعيد النظر في كُلفة الصمت الطويل.
في السياق الدولي، يأتي القرار الفرنسي ليضع الولايات المتحدة في مأزق إضافي. واشنطن التي تكرّر متلازمة "حل الدولتين" لم تُقدم يومًاً على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتواصل دعمها المطلق لإسرائيل سياسياً وعسكرياً. أما إسرائيل، فتستقبل القرار الفرنسي بحنق وغضب واتهامات بالنفاق والانحياز، متناسية أن الاعتراف لا يُنكر وجودها، بل يسعى لخلق توازن في مشهد مختل منذ عقود. إسرائيل ترى في الخطوة الفرنسية تهديداً لمسار فرض الأمر الواقع الذي تنتهجه، وتخشى أن يكون مقدّمة لتحرك أوروبي أوسع يُعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدبلوماسية الدولية.
أما في أوروبا، فقد جاء القرار ليُحرّك مياهاً راكدة. فالاتحاد الأوروبي، الذي طالما اكتفى بإصدار بيانات التنديد، يقف اليوم أمام لحظة اختبار: إما أن يُحوّل هذا الاعتراف إلى سياسة جماعية تضغط باتجاه حل عادل، أو يترك فرنسا تواجه الموج وحدها. بعض الدول، مثل ألمانيا وهولندا والتشيك، لا تزال مترددة، إمّا بسبب تاريخها المعقّد مع إسرائيل أو بفعل الضغوط الأميركية، لكن زخم الاعترافات المتتالية قد يخلق دينامية تُحرج المترددين وتُعيد تعريف التوازنات داخل الاتحاد.
اللافت في هذا المشهد أن المواقف العربية، رغم ترحيبها اللفظي، فلا تتجاوز حدود التصريحات التقليدية، وتحديداً الدول ذات العلاقات الوثيقة مع فرنسا التي تخشى أن تُفعّل القرار سياسياً ودبلوماسياً، ولن تبادر إلى خلق تحالف إقليمي أو دولي يبني على الخطوة الفرنسية وستبقى في حدود الإعلام دون ترجمة إلى تحركات ملموسة في المحافل الدولية، بينما دول التطبيع الجديد ستلتزم الصمت الحذر، خشية التوتر مع إسرائيل، ما يعكس تحوّلاً عميقًا في الأولويات الإقليمية، وتراجع مركزية القضية الفلسطينية في القرار العربي الرسمي.
يبقى أن نسأل: هل تمثل هذه الخطوة الفرنسية بداية لتحول أوروبي شامل، أم أنها ستظل حدثاً رمزياً معزولاً؟ هل ستقوى فرنسا على مواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية، أم تتراجع تحت وطأة الحسابات الاقتصادية والجيوسياسية؟ وهل سيستطيع العرب والفلسطينيون تحويل الاعتراف إلى رافعة دبلوماسية حقيقية، أم يكتفون بالتصفيق والتصريحات؟
إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين ليس نصراً نهائياً، لكنه بالتأكيد كسر لحالة الجمود الأوروبي، وصفعة للخطاب الغربي الذي طالما طالب الفلسطينيين بالتفاوض بينما أغمض عينيه عن الوقائع الاستعمارية على الأرض. إنه تذكير بأن القانون الدولي لا يُطبق فقط بقوة الجيوش، بل أيضاً بقوة المواقف الأخلاقية المتراكمة، لكن هذا الاعتراف يواجه تحديين أساسيين: أولهما، خطر أن يبقى رمزياً ومعزولاً ما لم يُترجم إلى اعترافات متتالية من دول الاتحاد الأوروبي، مصحوبة بضغوط حقيقية على إسرائيل، ومقاطعة دبلوماسية وعسكرية واقتصادية تحديداً. وثانيهما، غياب رافعة عربية وفلسطينية قوية تستطيع تحويل اللحظة إلى مسار سياسي ملزم يحافظ على ما تبقى من فلسطين ويوقف اختفائها اليومي من السجل الإنساني وزوالها من الجغرافيا والتاريخ؟
نشكركم على القراءة، ونتطلع لمشاركتكم في مقالاتنا القادمة للحصول على أحدث الأخبار والمستجدات.




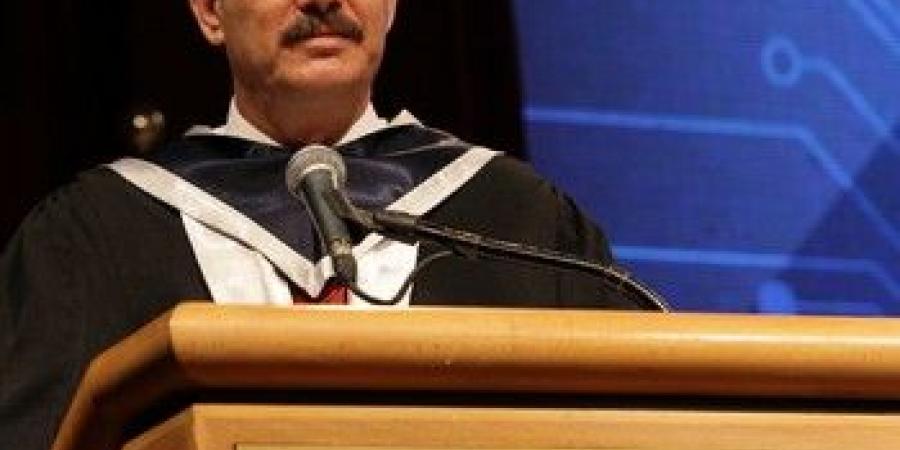






0 تعليق